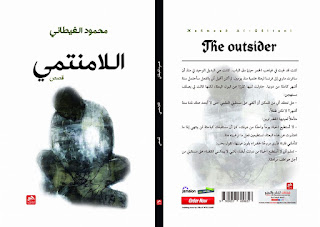هذه الرؤية الفنية المُختلفة تُعد هي لُب العملية الإبداعية القادرة على الخلق من جديد من خلال تأملات المُبدع؛ لذا من الطبيعي أن يكون هناك أكثر من شخص يشاهدون حدثا واحدا عاديا لا يحتمل أي دلالات غير طبيعية، لكن إذا ما كان من بين هؤلاء الناس مُبدعا واحدا؛ فسيرى الحدث بشكل مُختلف تماما عنهم، وسيصل من خلال تأمله الخاص إلى شكل آخر جمالي ودلالي قادر على إكساب المشهد الكثير من الدهشة التي تُعد الهدف، أو النتيجة الأولى والحقيقية للعملية الإبداعية؛ فالعمل الإبداعي الذي لا يستطيع إثارة الدهشة هو في جوهره عمل إبداعي ناقص لم يصل للنتيجة الطبيعية للعملية الإبداعية.
إن المقدرة على إثارة الدهشة، أو تحميل العادي بالكثير من الدلالات الجديدة التي لم يكن يحتملها من خلال النظرة العادية هو ما نُلاحظه أثناء قراءتنا للمجموعة القصصية "ثرثرة أمام جبل قاسيون" للقاصة الأردنية إنعام القرشي، وهو الأمر الذي يجعلنا نُعيد التأمل والنظر عدة مرات في العديد من الأحداث العادية التي تحدث أمامنا كل يوم لمحاولة استخراج الفني، أو المُدهش فيها مثلما كانت تفعل القاصة من خلال تأملاتها التي تسلمها إلى إعادة تشكيل الحدث والأشياء، وكأنها تُعيد ترتيب العالم وفقا لرؤيتها الفنية الخاصة بها.
هذه المقدرة على الخلق الجديد نراها في قصتها "بوست" من خلال حدث عادي نراه يوميا، وقد لا يلفت نظرنا، أو نتورط في المُشاركة فيه رغم سخافته، إلا أنها من خلال تأملها ورؤيتها الفنية أحالت العادي والسخيف إلى غير عادي وفني لتجعلنا ننظر إليه نظرة أخرى جديدة ومُختلفة تماما، تبدأ القاصة قصتها بكتابتها: "تسكب قهوتها برغوتها السميكة في فنجان الشاي، لم يعد الفنجان الصغير يساعد في سحب النعاس من أجفانها، تضعه فوق المدفأة كي لا يبرد، يترنح المزاج بين الصحو والإغفاء، ويتمدد الوقت. هطول المطر ليس كافيا للتخلص من المزاج السيء"، ربما سنُلاحظ من خلال الاقتباس السابق الذي كان بمثابة المدخل للقصة مُعاناة القاصة من حالة فراغ تؤدي بها إلى مزاج سيء كما صرحت في نهاية الاقتباس، كما لا يفوتنا كتابتها: "يترنح المزاج بين الصحو والإغفاء، ويتمدد الوقت" كدليل على الحالة المتراوحة بين المزاج الجيد والسيء، ولعل تمدد الوقت دليل على الشعور بالكثير من الملل.
إذن، فنحن أمام قاصة تعاني حالة من حالات الفراغ والمزاج غير المُعتدل، وهو ما يجعلها تحاول إزجاء وقتها الطويل، وتعديله من خلال تناول فنجانا ضخما من القهوة، لكننا إذا ما تتبعنا القاصة في عالمها سنقرأ: "ترشف القهوة. الله، لذيذة جدا! تمشي في اتجاه المذياع وترفع صوت أغنية فيروز، تنفث كل ما في صدرها من دخان، وينتابها شعور قاتل بالملل. كل شيء كما تركته أمس وأول أمس!"، إذن فهي توغل في وصف حالة الملل التي تعاني منها محاولة تغييرها بالاستماع إلى الأغاني، لكنها تظل مُلازمة لها.
ألا نُلاحظ أن الحدث ما زال عاديا لا فارق بينه وبين الثرثرة التي لا هدف منها؟ إن محاولة الحفاظ على عادية الحدث السردي واقترابه من الثرثرة المُملة كانت مُتعمدة تماما من الكاتبة؛ للحفاظ على المُفاجأة الفنية في نهاية قصتها، أو صناعة المُفارقة الفنية في نهاية الحدث، لذلك نقرأ: "تُعيد الفنجان إلى مكانه فوق المدفأة، يميل قليلا وتنسكب القهوة فوق الشبك المُلتهب. تش تش تش. الشُعلة لا تنطفئ! تعدله، ينحرف مرة أخرى. لا يحدث هذا دائما! قالت ذلك وهي تحاول أن توازن نفسها بأقل الخسائر بعدما تلوث الفنجان، كي لا يزداد مزاجها سوءا، لا شيء تغير!"، إنها هنا توغل في الحالة المزاجية السيئة، والشعور الشديد بالملل الذي يلازمها، وهي تتعمد هذا الإيغال في الحالة لتقوية المُفارقة في ختام قصتها؛ لذلك نقرأ في نهاية القصة: "تفتح حاسوبها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وتكتب "بوستا": فنجان قهوة، وصوت فيروز، ومدفأة في أجمل مزاج صباحي، أعطى للحياة لونا بخفة حروف دواوين شعر لا تكاد تستقر حتى تطير، صباحكم قهوة وشعر جميل أصدقائي". تُحمّل من "جوجل" صورة أنيقة لفنجان قهوة أمام مدفأة مُلتهبة وترفقها بالبوست لتنهال عليها التعليقات وأبيات الشعر الغزلية من المُعجبين بثقافتها الموسوعية التي لا مثيل لها، ومزاجها المُعتدل دائما الذي يمنحهم المزيد من السعادة"!
إذا ما تأملنا الاقتباس الذي أغلقت به القرشي قصتها سيتبين لنا المقصود من إعادة تشكيل وخلق العالم الذي سبق أن ذهبنا إليه؛ فالحدث العادي الذي ركنت إليه في قصتها هو امرأة شاعرة بالكثير من الفراغ والملل تحاول تعديل مزاجها بأي شكل بسيط سواء بالقهوة، أو الاستماع إلى الأغنيات، ولم يلبث الملل أن دفعها إلى كتابة "بوست" زائف عن مزاجها الجيد- ربما من أجل تعديل مزاجها- وإن كان الأمر يُدلل في جوهره على ثقافة الادعاء التي اكتسبناها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المُفارقة الفنية هنا تأتي من جملتها الأخيرة، وهي المُفارقة التي ستحيل السرد العادي الشبيه بالثرثرة إلى سرد فني يحمل دلالته الفنية الجديدة التي لم نكن نُلحظها فيما قبل حينما قرأنا تعليقات الآخرين على اللاشيء/ الهراء الذي كتبته؛ فرغم أن المرأة لم تكتب أي شيء له قيمة، كما أن المكتوب لا يحمل في طياته أي معنى للفن، أو أي دليل على ثقافتها الموسوعية، إلا أن هناك العديدين من المُدعين والزائفين- ربما لكونها مُجرد أنثى- كتبوا لها أبيات الشعر الغزلية، وأبدوا إعجابهم بثقافتها الموسوعية التي لا مثيل لها- ولسنا ندري أين هذه الثقافة الموسوعية فيما كتبته- بل ويزداد الأمر إدهاشا ومُفارقة حينما يتحدثون عن مزاجها المُعتدل دائما الذي يمنحهم المزيد من السعادة! فهي ليست في أي مزاج مُعتدل، كما أنها في واقع الأمر لا تمنحهم أي شيء من السعادة، بل ربما لا يلتفت إليها أحد إلا لكونها أنثى يرغبون فيها فقط! أي أن المُفارقة التي ختمت بها القاصة قصتها تحمل في داخلها السخرية العاتية من الوضع الاجتماعي والثقافي العام الذي نراه كل يوم من حولنا، لكننا لا نتوقف أمامه كثيرا من أجل تأمله، أو محاولة إكسابه شكل فني مُختلف عما يبدو عليه، وهذا هو دور الفن الذي نتحدث عنه.
في قصة "صفعة" يتجلى لنا دور الفن في الخلق وإعادة ترتيب العالم بشكل أكثر فنية ومُفارقة من خلال فتاة ينقطع إبزيم حذائها أثناء لهوها؛ الأمر الذي يجعلها تخفي الأمر عن أبويها، وتضطر يوميا إلى الذهاب إلى مدرستها بحذائها المقطوع والذي تعاني كثيرا في المشي به، لكنها تُلاحظ أحدهم دائما ما يراقبها، يوميا، في رواحها وغدوها بحذائها المقطوع بينما تشي نظراته بالكثير من السخرية منها؛ مما جعلها تشعر بالكثير من الحرج وعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة حتى لا تواجه نظرات الرجل الغريب الساخرة، فنقرأ: "من الصعب أن تكون المسافة قصيرة بين المدرسة والبيت وأنت ترتدي حذاء مخلوع الإبزيم، فالتا في الهواء! أشار لها بعض المارة سريعا بأنها نسيت أن تُحكم الإبزيم- لكنها وحدها- من كان يعلم أن الإبزيم مخلوع من مكانه، ولا مجال لإحكام أي شيء. هل كان يجب أن ينتقل والدها في كل مرة إلى مكان جديد كي تطول المسافة أكثر فأكثر؟ سؤال ظل يدور في ذهن الصبية الشقراء صاحبة الحذاء المنكوب"، إذن فالقاصة مُنذ جملتها الأولى حريصة على الدخول إلى قلب الحدث القصصي واقتحامه، إننا أمام أزمة طفلة تشعر بالكثير من الحرج، ولا يدور في ذهنها إلا العديد من التساؤلات بسبب ما يسببه لها الإبزيم المقطوع من حرج أمام الآخرين، وهو ما تعمل على تعميقه بقولها: "لو أنه يتوقف عن النظر إلى الحذاء، نظراته تُربكني، تُعثر خطواتي، ولا أستطيع السير بشكل صحيح، تنزلق قدمي فيه من التعرق، وفي بعض الأحيان تخرج منه كليا، ويتأخر خلفي بخطوتين؛ ما يستدعي أن أعود إليه وأحشر قدمي في داخله مرة أخرى! وهذا يسبب لي الإحراج كثيرا. كانت تعنيه بهذه الكلمات، ذلك الشخص الذي تراه كل يوم في طريقها صباحا إلى المدرسة، تشعر بحدة نظراته التي يوجهها إلى حذائها، وهي تحاول جرّه بقدمها كي لا تتأخر، وتحمله- أحيانا- وتنطلق راكضة لتصل في موعد الجرس، تنتعله أمام باب المدرسة دون أن يراها أحد. تستغرب إصراره على مُلاحقتها بنظرات الاشمئزاز والترفع، وكيف يدفع بها للشعور بالوحدة وعدم الانتماء إلى المكان. تظن لحظة أنها سوف تسحق نفسها كحشرة لا يحق لها الحياة، بينما يمعن التدقيق في حذائها كأنه يجلد تفاصيله".
إن إمعان القاصة في تصوير وشرح مشاعر الطفلة واستغراقها فيها كان من الأهمية الفنية بمكان ما سيُدلل لنا ويوضح سبب الفعل الذي ستقدم عليه فيما بعد، ولعلنا نُلاحظ الحالة النفسية والشعورية التي وصلت إليها الفتاة بسبب هذه النظرات المُشمئزة منها لمُجرد أنها تنتعل حذاءً مُنقطع الإبزيم؛ حتى أن ارتباكها يجعله ينخلع من قدميها بسبب ما يسببه لها من شعور بأنها مُراقبة من قبل شخص ما يحتقرها، أو يسخر منها. هذا الشعور بالضآلة والحرج الذي تضخم داخلها جعلها: "خطر في بالها أن تتمارض وتغيب عن المدرسة، لكنها استبعدت الفكرة، نهضت وفتحت الخزانة، وأخذت تبحث بين أشيائها لعلها تجد حلا. وجدت دبوسا قد يفي بإصلاح المهدور مُؤقتا ريثما تجد حلا آخر. وضعته أسفل مخدتها، لكنها لم تستطع النوم. ظلت تُحدق في سقف الغرفة الذي تراءى لها مليئا بالأحذية حتى غفت. كان الحلم أجمل بكثير، أعادها إلى غياهب الماضي، فمرة تكون سندريلا، ومرة أخرى تكون الأميرة النائمة، لكنها لم تستطع امتلاك أدنى إحساس في قلبها بالفرح أو الحزن، أو القدرة على التفكير في أي شيء آخر سوى إبزيم الحذاء الذي حجب عنها كل أمير حولها. نسيت خطوات الرقص من شدة تحديقها في حذائها المتوهج الخرافي"، أي أنه قد أوصلها إلى عدم الرغبة في الذهاب إلى مدرستها حتى لا يراها، كما جعلها ترى الكثير من الأحلام التي تخص الأحذية في الثقافة الجمعية، لا سيما سندريلا.
لكن، هذا الحدث الذي قد يبدو عاديا ويوميا، ونراه كل يوم، تحرص الكاتبة على إكسابه معنى آخر وجديد تماما، وهو ما نراه في إغلاقها القصة بشكل لم نكن ننتظره أو نتوقعه من فتاة في مثل هذا العمر؛ فنقرأ: "في الصباح نهضت مُبتسمة، تشعر بهمة عالية، تزينت أمام مرآتها بثقة. رفعت رأسها بشموخ في أثناء سيرها، بينما كان الحذاء- بين الفينة والأخرى- ينزلق من قدمها كالعادة. لم يعد يعنيها انزلاقه بقدر ما كانت تفكر في صاحب النظرات الوقحة الذي سبب لها الكثير من الألم في الأيام الماضية. تدور بنظراتها كأنها تبحث عنه. ظهر أمامها- فجأة- ترتسم على وجهه نظرته الساخرة- نفسها- التي تشملها من رأسها حتى إخمص قدميها. ترتكز نظراته على حذائها ذي الإبزيم المخلوع. اقتربت منه وقد ارتسمت على وجهه بسمة شائهة لا تفسير لها، ما أن وقفت أمامه حتى بدأت ابتسامته في الانزواء مُتحيرا. انحنت إلى الأسفل كأنها تحاول تعديل وضع الحذاء في قدمها. تابعها بنظراته، لكن اللحظات القليلة التي تلت انحناءتها لم يكن لها تفسير حينما التقطت الحذاء في يدها وصفعته به على وجهه لتعيده مرة أخرى مُستمرة في طريقها مرفوعة الرأس وقد اتسعت ابتسامتها"!
إن حرص إنعام القرشي على إغلاق القصة بمثل هذا الشكل المُفاجئ هو ما نُطلق عليه المُفارقة التي تُكسب العمل الفني دهشته، وتخرجه من إطار العادي إلى الإطار الإبداعي والفني، أي أنها تمتلك من المقدرة الفنية ما يجعلها تستمتع بالخيال الذي يغير من طبائع الأمور إلى ما هو مُدهش مُمتلكا للكثير من الرؤية الفنية، فكان إغلاقها للقصة، هنا، صفعة لنا جميعا بقدر ما كانت صفعة لمن يسخر منها!
في قصة "صوت الشجن" نُلاحظ اهتمام القاصة بتشكيل العالم تبعا لرغباتها الداخلية المكبوتة، أي الرغبات التي تشعر بها ولا تستطيع البوح بها لمن حولها؛ الأمر الذي يجعلها تتخيلها لتحيل المكان من حولها إلى مكان آخر لا وجود له في الواقع بقدر ما هو بداخلها هي فقط! تكتب إنعام مُفتتحة قصتها: "أسندت ظهري إلى الحائط، وبدأت أقضم رغيف خبز أسود محشوا بالجبنة الفرنسية المُدخنة؛ فشعرت حينها بطعم الدخان. كنت أقضم الرغيف بينما كان صوت موسيقى حزينة ينساب إليّ من نافذة أحد البيوت. لم تكن لدي الرغبة في التفاعل معها حتى لا أشعر بالشجن. لطعم الجبنة المُدخنة في فمي مذاق الحياة. أنشغل بسد جوعي، ألوك اللقمة طويلا لأستمتع بمذاقها أطول فترة مُمكنة. يعلو صوت المُوسيقى، أحاول مقاومته حتى لا أنشغل عن المذاق الذي أحبه". ألا نُلاحظ هنا أن القاصة حريصة دائما على أن تبدأ أحداث قصصها بشكل لا يمكن له أن يخرج من إطار الثرثرة التي لا معنى لها؟ بالتأكيد هي حريصة على ذلك بشكل مُتعمد؛ لأنها تُحيل العادي فيما بعد إلى شكل فني مُختلف عما بدأته، وهو ما سنُلاحظه مع استمرارها في السرد: "أتوجه ببصري حيث النافذة التي تنساب منها الألحان. كان زجاجها مُغلقا، لكني ألمح أشياء تتحرك خلفه. أدقق النظر بينما أنا مُنهمكة في لوك لقيماتي واستحلابها في فمي حتى آخر قطرة. ألمح جسدين عاريين يتداخلان بانسيابية كأنهما يشاركان المُوسيقى عزفها. أرهف السمع وقد توقفت عن المضغ. تتركز حواسي بالكامل في عينيّ وأذنيّ. أراهما يمتزجان، يتحدان كأنهما باتا جسدا واحدا بينما يختلط أنينهما بصوت المُوسيقى الشجي الأقرب إلى الحزن. يبدو لي أن عذوبة صوتهما أجمل بكثير من اللحن الذي يستمعان إليه. أشعر بشيء يسري في جسدي وأنا أشاركهما هذه اللحظة المُوسيقية، بينما تتابعهما عيناي وقد توسعتا، أقضم وقد فقدت جبنتي المُفضلة مذاقها. أمضغها دون إحساس لتسقط في جوفي. تحوّل مضغي الطعام إلى عملية آلية لا تعنيني".
بغض النظر عن الخطأ في مُفردة "توسعتا" بدلا من "اتسعتا"، في الاقتباس السابق يتحول، هنا، السرد الأقرب إلى الثرثرة إلى سرد يكتسب المزيد من الحيوية حينما تستمع إلى صوت تأوهات عاشقين خلف زجاج إحدى النوافذ وتبدأ في مُراقبتهما شاعرة بشيء من النشوة لرؤيتها لهما. أي أننا سنظن أنها ستندمج في هذه العملية الجنسية التي لا بد لها من الاسترسال فيها ووصف حميميتها، لكننا نُفاجأ أن القاصة لا تنساق خلف اعتقادنا في وصف ما تراه، بل تقطع فجأة على صوت شقيقتها التي تسألها عما تنظر إليه؛ فتطلب منها هامسة مأخوذة النظر إلى النافذة التي تقابلهما، لكن رد شقيقتها هو ما يُكسب الحدث القصصي قيمته ومكانته الفنية حينما نقرأ: "تتجه بعينيها حيث أشرت، لكنها تعود ببصرها مُندهشة لتسأل: ماذا هناك؟! بصوت يبدو مُرتعدا: هذه النافذة هناك، تلك التي يصدر منها صوت المُوسيقى. تنطلق- فجأة- ضحكة مدوية من فم شقيقتي، تقول أثناء انصرافها: أي نافذة هذه! المساحة المُقابلة لبيتنا، بالكامل، مُجرد أرض فارغة، يبدو أنك قد جُننت. أندهش لقولها؛ فأعيد النظر حيث كنت أتلصص عليهما، لكني لا أرى سوى أرض فارغة مُتسعة المساحة!"
إن إغلاق القصة بمثل هذا الشكل بعد إيهامنا بأنها كانت تراقب عاشقين يمارسان الجنس هو ما يكسبها فنيتها في نهاية الأمر؛ فالشخصية داخل القصة إنما تتأمل العالم من حولها، وتعيد بنائه وتشكيله من خلال خيالها الذي يحركه رغباتها الخفية التي لا يعرف عنها أحد شيئا، وبالتالي فهذه الرغبات قد خرجت في شكل واقع بالنسبة لها لتتشكل أمامها مُستمتعة بها، لكنها سُرعان ما عادت إلى العالم الواقعي الذي أثبت لها أن الخيال ربما يكون أفضل من الواقع في بعض الأحيان، ويعمل على تجميله.
هذا الخيال الذي يسيطر على شخصيات إنعام القرشي القصصية، وهو الخيال الذي ينجح إلى حد كبير في إعادة تشكيل الحياة ووقائعها من خلال وعيها الفني بكيفية كتابة القصة القصيرة هو ما نراه مرة أخرى في قصتها "كابيتشينو" التي ترغب من خلالها في الانتقام من الزوج الذي كثيرا ما اعتدى عليها بالضرب، لكنها لا تمتلك الحيلة من أجل الرد عليه بالمثل؛ لذلك تفتتح القصة بالدخول إلى قلب الحدث مُباشرة: "خرجت وهي تصرخ: كفى، لقد ضيّعت الكثير من الوقت، آن لك أن تتوقف. تسحب منديلها لتمسح قطرات الدم النافرة من أنفها، تعتدل في جلستها على الكرسي الخشبي الطويل داخل حديقة يرتادها الكثير من الجاليات الأجنبية. يبدو الجو مُناسبا لكوب من الكابيتشينو. سأراقبه وهو يتعثر أمامي، سأركله بقدمي، لن أكون رحيمة معه. تتمتم، ثم تغادر الكرسي صوب المقهى: لو سمحت، كابيتشينو. تشعر بالهدوء بينما تشرب الكابيتشينو الدافئ. يجعلها رذاذ المطر البهيج تفتح فمها لقطراته، تهز رأسها طربا وهي تُدندن. يُفاجئها النعاس؛ فتميل على حافة المقعد، وتغطي عينيها بحافة القبعة وتغفو". إن الاقتباس السابق الذي افتتحت به القرشي قصتها يُدلل على أنها قد دخلت إلى قلب الحدث بشكل مُباشر من دون أي تمهيد، وهو ما يُكسب القصة الكثير من الإيجاز، ولعلها كانت حريصة على أن تبدي رغبتها في الانتقام منه بالرد على ضربه لها بنفس الفعل، وهو ما تخيلته قبل إغفاءتها. لكن حينما يشتد هطول المطر تفتح عينيها لتجد المكان قد امتلأ بالكثيرات من الأمهات والأطفال الذين يلتفون من حولها طالبات منها أن تتبعهن مُتجهات إلى منزلها، وحينما تدخل إلى المنزل تجده ما زال جالسا في ملابسه الداخلية المُهترئة، بل تقوم الأمهات بتقييده ليضربنه انتقاما لها، طالبات منها مُشاركتهن في ضربه: "يأمرنها بركل مُؤخرته بقوة. تفعل ذلك بينما تسري في جسدها بهجة تُشعرها بالانتشاء. كلما ركلته بقوة أكبر صرخ محاولا الإفلات من أيديهم، لكنهم يشدون وثاقه بقوة أكبر. تلكم أنفه حتى ينبجس الدم سائلا منه. يتوسل إليها أن ترحمه، لكنها لا تتوقف. ينظر إليها بضعف شديد ليخرج صوته واهنا مُتأدبا: هل اكتفيت؟"، أي أن الزوجة قد استطاعت الانتقام لنفسها من الزوج الذي يهينها ويضربها دائما بمُساعدة الأمهات اللاتي قابلتهن في المقهى.
لكن، المُفاجأة الفنية التي تحرص عليها القرشي تتبدى لنا إذا ما أكملنا ما كتبته بعد سؤاله لها هذا السؤال السابق، فنقرأ: "تفتح عينيها، فجأة، مُلتفتة حولها لترى كوب الكابيتشينو فارغا تماما، بينما يقف النادل أمامها ليسألها بأدب عن إمكانية رفعه"! إن مصدر المُفاجأة هنا أن القاصة كانت قد حرصت فيما قبل على التأكيد بأنها قد استيقظت حينما ازداد هطول المطر، أي أنها اهتمت بالإيهام؛ كي يقع في نفس القارئ بأن الحدث حقيقي، لكنها عادت مرة أخرى لتؤكد لنا أن ما لجأت إليه كان مُجرد إيهام، وأن كل ما قرأناه من أحداث في القصة مُجرد خيال الشخصية داخل القصة، أو رغبتها العارمة في الانتقام، وبالتالي فالحدث كان مُجرد حلم رأته وكانت راغبة في تحقيقه، كما أن سؤال الزوج لها: هل انتهيت، كان في حقيقته صوت النادل الذي سألها هذا السؤال، لكن الواقع اختلط بالحلم، وهو ما يؤكد أن القاصة تمتلك أدواتها الإبداعية التي تساعدها إلى حد بعيد على الوصول إلى ما ترغبه بشكل فني، لا سيما إيهام القارئ ثم صفعه مرة أخرى كي يفيق من هذا الإيهام الذي أدخلته فيه.
إن امتلاك القرشي لأدواتها الفنية، وفهمها لكيفية كتابة القصة القصيرة يتجلى لنا في العديد من قصص المجموعة؛ حيث تنجح غير مرة في صناعة المُفارقة القصصية التي تفجر في نفس القارئ الدهشة، وهو الشعور الأهم في العملية الإبداعية. هذا ما نُلاحظه في قصتها "بدلة حال لونها" التي نُلاحظ فيها أنها رغم بساطتها تمتلك من المقدرة على صناعة القصة وخلق العالم بشكل مُتقن؛ فنقرأ: "جلسا، أخيرا، في المقهى على طاولة لشخصين، نظر إلى وجهها، ابتسم، فابتسمت. نظرت إلى ملامحه كأنها تتعرف عليه من جديد. تقول في نفسها: ما يزال يلبس البدلة نفسها التي كلح لونها، كم هو بخيل! حتى هذه العادة لم تتغير فيه، يحمل كيسا كاكي اللون، ولا يسألني ماذا أشرب، ويختار لي القهوة التي لا أحب شُربها وقت العصر! لا أظن أن يكون بيننا أي نوع من الانسجام بعد اليوم، سأعترف له بأنني سأسافر وأحل أمري من الموضوع"، إذن، فنحن أمام عاشقين قد التقيا بعد فترة انقطاع، أو خلاف، بينما نُلاحظ أن المرأة تُعيد النظر في علاقتها معها، وطباعه التي تكرهها فيه، لكننا إذا ما استمررنا مع القاصة فيما تكتبه بعد هذا المقطع سيختلف الأمر كثيرا: "كيف حالكِ وما أخباركِ؟ لم كل هذا التُقل؟ لا، أبدا، ظروف. يحدق فيها وهي تتكلم، يُحدث نفسه: أصبحت أجمل، وزاد عدد الأساور في معصمها، ذهب حقيقي، نعم، هذه السلسلة التي تمسك بها وتحرك إطارا ذهبيا لمُصحف جميل وثقيل مُعلق بها، حتى الحقيبة، لم تعد تلك التي كانت معها من قبل، هذا يعني أن وضعها المادي تغير إلى الأفضل"، أي أنها إذا ما كانت تحاول تأمله من خلال خصاله التي تكرهها فيه، وكانت تأمل أن يكون قد تغير إلى الأفضل لتستطيع أن تكمل معه، فإنه ينظر إليها نظرة مُختلفة تماما طامعا في مالها الذي تمتلكه بينما لا يحمل تجاهها أي قدر من المشاعر الحقيقية؛ لذلك حينما تسأله أثناء شروده في تأملها: "لم لا ترد؟ سألته بتعجب. آسف لقد سرحت قليلا. بماذا؟ هل تتزوجينني؟"!
هنا تكون المُفارقة القصصية لقصة قد تبدو عادية جدا، ولعل الدليل على امتلاك القرشي المقدرة القصصية وفهمها بشكل جيد قد اتضح لنا من خلال الإيجاز الذي لم تكتبه وإن كان قد وصلنا، فنحن لم نقرأ السؤال أو الكلام الذي قالته له حتى يرد عليه، بل قرأنا سؤالها المُباشر له، لكننا سنفهم أنها قد تكون قد أخبرته بأنها ستسافر ولن تستطيع إكمال العلاقة معه، وبما أنه كان شاردا فهو لم يسمع ما تقوله، بل كان غارقا في طمعه في أموالها، لذلك كان رده عليها هو طلب الزواج منها كي يمتلكها، ويمتلك أموالها، رغم أنها قد تكون قد أخبرته برغبتها في عدم الانخراط معه، لكن بما أنه لا يستمع سوى إلى نفسه؛ فلقد طلب منها الزواج الذي اختتمت به القاصة قصتها بشكل قد يبدو مبتورا، وإن كانت هي حريصة على هذا الشكل الباتر الذي يكسب القصة المزيد من الفنية، والتأكيد على فهمها لآليات كتابة القصة.
في قصة "المشهد الأخير" قد تبدو لنا القصة كمُزحة كتبتها القاصة، لكنها رغم ذلك تمتلك من المُتعة السردية ما يجعلها تُصرّ على كتابتها محاولة من خلالها التعمق داخل سيكولوجية المرأة التي هي أقرب إلى سيكولوجية الأطفال من خلال امرأة رأت أحد المشاهد الفيلمية ورغبت في تجربته والاستمتاع به على أرض الواقع؛ فتبدأ قصتها بمشهدها الأثير: "عندما تحسست المُمثلة "أودري هيبورن" بإصبع قدمها حرارة الماء في حوض الاستحمام، كانت سلوى تسير حاملة قهوة أمها إلى "البلكونة". استوقفها المشهد، وتابعت الفيلم حتى انتقلت الكاميرا إلى ستارة الحمام المُنسدلة، والمُعبأة ببخار الماء في حين يعلو صوتها بأغنية رقيقة، نثرت حولها فقاعات الشامبو التي غطت عدسة الكاميرا، وظهرت كلمة The End"، أي أننا أمام مشهد سينمائي عادي في أحد الأفلام، لكنه استوقف سلوى التي شغلها المشهد وظل في خيالها لا يبارحه راغبة في تجربته بنفسها على أرض الواقع: "جلست سلوى تُعيد أدق تفاصيل المشهد في ذهنها، ورأت أن خوض تجربة كهذه تكريما لذاتها في استقبال العام الجديد، لن يكلفها الأمر سوى إحضار صابونة مُعطرة بدلا من شامبو الفقاعات ليكتمل المشهد، فتكون بديلة أودري هيبورن في فيلم حديث"؛ لذلك تجلس سلوى مع أمها محاولة إقناعها بالصلح مع خالتها التي قاطعتها الأم مُنذ فترة طويلة، ودفعها من أجل زيارتها، وحينما تقتنع الأم ذاهبة إلى شقيقتها، تنفرد سلوى بنفسها لتُعد طقوس ما ترغب في فعله: "امتلأ نصف الحوض، غطى البخار كل شيء حولها، أسندت كفها إلى الحائط وهمّت بوضع إصبع قدمها لتتحسس سخونة الماء، تماما كما فعلت المُمثلة. سُحلت كفها فجأة فانقلبت داخل حوض الاستحمام. صرخت وغضبت، غير أنها تريثت، ولم تشأ أن تفسد أجواءها بسبب تعثر لم يسفر عنه إلا بلل المنشفة. قالت في سرها: ربما حدث هذا مع المُمثلة أودري عدة مرات. ارتاحت لهذا التحليل وهي تنظر إلى الصابونة المُعطرة داخل علبتها الملونة على حافة حوض المغسلة، مممم! كيف سيكتمل المشهد وينتهي بالغناء إذا لم تستخدم الصابونة؟ هكذا بدا من ابتسامة خفيفة لا تُفارق شفتيها، لا سيما أنها مُنسجمة مع دندنة الأغنية نفسها بصوت خفيض. خطوتان فقط، وتملأ رغوة الصابونة وجه الماء! هكذا أقنعت نفسها. تمسكت بحافة الحوض، وتعلقت بالستارة، وانكبت على المغسلة خوف أن تنزلق مرة أخرى، وأمسكت الصابونة. ثبتت قدمها، وعادت- بحركة سريعة- إلى حوض الحمام، اهتزت الستارة فخُلع عمودها الصدئ ووقع فوق ظهرها، صرخت وغرقت مع صراخها في الماء من شدة الألم. أصابها الإحباط، تنفست عميقا، لكنها حاولت أن تُعيد لذهنها قليلا من البهجة. استرخت وهي تُدير الصابونة بين يديها وتملأ وجه الماء برغوتها وتُعيد سماع الأغنية برأسها، تغير مزاجها رغم الألم، وطمعا في الاسترخاء أكثر؛ أسندت رأسها إلى الخلف، حاولت وضع المنشفة أسفل عنقها، لكن شدة الألم زادت. كيف لم أنتبه إلى هذا الجزء؟! تمتمت. نظرت حولها لعلها تجد الحل. لمحت الليفة الخشنة مُعلقة قرب "الدوش"، مدت يدها وأمسكت بحبلها المُتدلي وسحبته باتجاهها، لكنه علق، شدته بقوة أكبر فسقط "الدوش" بغفلة منها وارتطم بوجهها مُباشرة، وأصاب أنفها الذي نفر منه الدم. صرخت بذعر بعد أن رأت الفقاعات وقد تلوّنت بالدم، نهضت تتحسس الطريق إلى المغسلة، ورشقت وجهها بالماء البارد وهي تضغط أنفها لإيقاف النزيف. نظرت في المرآة وهالها أنفها المُنتفخ، ووجهها المُلطخ بالدم المُتجلط. مسحت البخار بكفها. وكتبت فوق المرآة بأصابع مُرتجفة بينما كانت تُدندن أغنية ثورية تحفظها جيدا: أنا ضحية مشهد لن يكتمل"!
ألا تبدو لنا القصة بالكامل كمُجرد مزحة؟ إنها بالفعل تبدو كذلك إلا أن الكاتبة كانت حريصة على كتابتها بأسلوبيتها القصصية الجيدة؛ لتتعمق في سيكولوجية المرأة الطفولية التي تحمل الكثير من المشاعر المُرهفة، والراغبة دائما في إشعار نفسها بالسعادة من خلال أي تجرية حتى لو بدت بسيطة وطفولية، أو ساذجة؛ فالمهم هو أن تكتسب قدرا من السعادة التي تجعل مزاجيتها جيدة، وبما أن الإبداع في جوهره يهدف إلى المُتعة، فنحن لا نستطيع إنكار أن الهدف من هذه القصة في نهاية الأمر إكساب القارئ شيئا من المُتعة التي تُعد جوهر العملية الفنية برمتها.
في قصة "صورة" تتأمل القاصة زيف المُجتمع من حولها الذي يدفع الجميع للتعامل مع بعضهم البعض بشيء غير قليل من الكذب، لا سيما تعامل الرجل مع المرأة الذي قد يبدي لها الاحترام الفائق، بل ويصفها بصفات غير واقعية بعيدة عنها كل البُعد ولا يمكن لها أن تتحلى بها في مُقابل رغبته الجنسية فيها فقط، أو لمُجرد أنها أنثى يطمع في النيل منها. تتناول الكاتبة فكرتها من خلال مُمثلة ليست مشهورة فتكتب: "تقف مُرتبكة وشعور الخجل يقفز خارج الإطار، لِمَ يقف هؤلاء الذكور الخمسة حولي؟! هل يظنون أنني مُمثلة جيدة وجميلة؟ كيف أصدق أن أيا منهم قد رآني في إحدى حلقات مُسلسل مثلت فيه، أو دفع ثمن تذكرة لحضور مسرحية لي؟ يقفون كأعمدة كهرباء خشبية قديمة، لأنني أقصرهم، أشعر بالكثير من الحرج! يلتصقون بي ببلاهة لأخذ صورة برفقتي، هل يعرفونني حقا؟ لِمَ لم يسألني أي منهم عن خطتي للمُستقبل؟! أرتدي قميصي قصير الكمين، وأضطر إلى أن أضم يديّ لأحمل الحقيبة، فأنا محشورة في وسطهم، وهم لا يتقنون فن المسافات، عليهم أن يفهموا أن لي خصوصيتي حتى إن كنت مُمثلة شهيرة! أبتسم وأميل برأسي قليلا باتجاه كتفي اليمنى لتكتمل الصورة. هل أنا مُمثلة ذات قيمة؟ بت أشك في ذلك! أنظر إلى ذراعي البضتين ناصعتي البياض، والسلسلة الذهبية المدلاة فوق صدري، الآن أجزم سبب ما أحدث جلبة في المكان، لقد فُضحت النية. أنظر إلى الصورة وأحقد على الكاميرا الذكية التي لمحت فتنة ذراعيّ العاريين، بينما يبدو عند التقائهما بكتفيّ منبتيّ صدري وفتنتهما!".ربما حرصنا على سوق القصة بالكامل هنا لأنها رغم إيجازها إلا أنها توضح التناقض الحقيقي والزيف الذي يتمتع به الجزء الأكبر من المُجتمع لا سيما حينما يتعامل مع امرأة ما؛ فيضفي عليها الكثير من التعبيرات والتوصيفات التي قد تكون لا تتمتع بأي منها، ولكن بما أنها مُجرد أنثى يطمع الآخرون في النيل منها؛ فهم يضفون عليها كل ما يمكن أن يكون جميلا، ولعل هذ الزيف الذي تعيه الشخصية جيدا داخل القصة يتجلى لنا في سؤالها: "هل أنا مُمثلة ذات قيمة؟!"، إنها تُدرك جيدا أنها ليست بهذه القيمة الفنية التي تجعل الآخرين يتهافتون عليها بمثل هذا الشكل، لذلك ستظل على تساؤلاتها إلى أن ترى الصورة التي تُظهر جزءا من نهديها؛ فتُدرك جيدا أن هذا التهافت سببه جسدها الجميل، وكونها مُجرد أنثى يطمعون فيها، أي أن القرشي رغبت في فضح زيف المُجتمع من حولها في التعامل مع المرأة، لا سيما المرأة التي تعمل في أي مجال إبداعي، من خلال هذه القصة المُعبرة بشكل فني جيد، وهو الزيف الذي يرفع الكثيرات من النساء إلى مصافٍ عالية رغم جهلهن، وتفاهتهن، لمُجرد أن الرجال لا يستطيعون السيطرة على رغباتهم الجنسية فيها؛ فيبدأون في نفاقها وتزييف كل ما حولهم.
لكن، رغم وعي القرشي بما تكتبه من أعمال قصصية، ورغم أنها تمتلك أسلوبيتها وآلياتها في كتابة القصة القادرة على خلق عالم إبداعي، إلا أنها وقعت في الفراغ الكامل، وقدمت قصة لا معنى لها، ولا يمكن لها أن تؤدي بنا إلى أي شيء في قصتها "أزهار ذابلة"؛ مما يجعلنا نتساءل: إلام ترغب الكاتبة في الوصول من خلال هذا الكلام المصفوف إلى جوار بعضه البعض، والذي لا يؤدي إلى أي معنى من المُمكن لنا أن نقبض عليه بعد انتهاء قراءتها؟!
بما أن القصة كجُمل من المُمكن لنا فهمها مُنفردة، ولكن إذا ما أُضيفت إلى الجُملة المجاورة إليها تفقد معناها؛ فسنحرص على سوق القصة بالكامل: "لأنه مُتعب، بدا هذا جليا على قسمات وجهه؛ ينام على حافة السرير مُنكمشا، ويضع كفيه بين ركبتيه، بينما يسقط الغطاء الأبيض على الأرض مثلما يفعل كل يوم. غرفة المكتب محشوة بالكتب القديمة. صوت مُمرضته بالكاد يُسمع: سيدي هل أنت في حاجة إلى شيء؟ الشاعر: لا حرية لروحه المُعذبة بين الجدران، ولا وجود لجسده المُنهك خارج الكلمات. يحدق مليا في سقف غرفته في المُستشفى؛ فيخال أن هنالك أشكالا غامضة تُحاكي قصص أحلامه المُستعصية، وجوه أبطال كادحين، وقساة لصوص، وناكري جميل هاربين من قسوة الزمن إلى البعيد. ما الذي أريده؟ يسأل، ولأن السؤال يغادر مع سُحب الدخان المُتطاير من بين أصابعه النحيلة؛ فلا إجابة. يبحث عن حذائه القطني أسفل السرير، يمشي إلى النافذة، يرى الشجرة الضخمة في مكانها تحجب الأفق."!
هذه هي القصة بالكامل كما كتبتها القرشي، وهي القصة التي تجعلنا نتساءل: لماذا نكتب، وماذا نكتب؟ إن المجموعة، بشكل عام، تؤكد أن الكاتبة تمتلك من المقدرة الفنية ما يجعلها تكتب القصة بشكل جيد، كما أنها تتقن صناعة العالم القصصي وتعيد تشكيله، لكن لِمَ قد ينساق الكاتب، أحيانا، رغم مقدرته الفنية إلى الثرثرة التي لا داعي لها، والتي تؤدي إلى الفراغ الكامل؟ إن القصة لا معنى لها، ولم تؤد بنا في نهاية الأمر إلى أي شيء، وبالتالي لم نفهم ما تقصده الكاتبة، أي أنها كتبت بلغة عربية غير مفهومة لا يمكن أن تؤدي بنا مُفرداتها إلى أي شيء نتيجة انسياقها خلف شهوة الكتابة لمُجرد الكتابة من دون فكرة أو معنى من المُمكن لها أن تقبض عليه كي تقدمه لنا.
تأتي المجموعة القصصية "ثرثرة أمام جبل قاسيون" للقاصة الأردنية إنعام القرشي باعتبارها من الأعمال القصصية المُهمة القادرة على التأكيد بأن القصة القصيرة من الأشكال الفنية القادرة على خلق العالم وإعادة بنائه وتشكيله من خلال الرؤية الفنية للقاص، أي أن الحدث العادي والطبيعي الذي نراه يوميا في حياتنا، والذي قد لا نلحظ فيه أي شيء من المُمكن أن يلفت انتباهنا قد يكون حدثا جللا ومُهما بالنسبة للقاص الذي يمتلك أدواته الفنية، ورؤيته الفنية الجيدة من أجل إعادة تشكيل هذا الحدث بشكل جديد يمنحه هذه الأهمية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الإبداع قادر دائما على التعبير عن العادي بشكل يفقده عاديته ويكسبه الكثير من الفنية والجمالية، كما لا يمكن إنكار وعي الكاتبة بفن القصة القصيرة ودوره المُهم في صناعة العالم من حولنا، ومقدرتها على كتابة القصة بفنية عالية.
محمود الغيطاني
مجلة مصر المحروسة.
عدد سبتمبر 2021م.